بقلم د.عمرو الشوبكى ١٢/٦/٢٠٠٨
لم يكن حادث دير أبوفانا في محافظة المنيا هو الأول في مسلسل الحوادث الطائفية، وبالتأكيد لن يكون الأخير، فالحادث الذي أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين، معظمهم من رهبان الدير، كشف عن أزمة عميقة في طريقة تعاطي الدولة مع الملف القبطي، مثلما هو حادث مع باقي الملفات.
وتعود القصة ـ كما أشار زميلنا محمد رضوان علي صفحات «المصري اليوم» في ٨ يونيو الماضي في واحد من أكثر التعليقات اتزانا ومهنية حول الموضوع ـ إلي أن الخلافات علي المنطقة المحيطة بدير «أبوفانا» بملوي، تعود إلي بداية عام ٢٠٠٥، وأنها شهدت في العامين الأخيرين عدداً من المشاجرات والمعارك المسلحة، بين مسؤولي الدير وأهالي المنطقة، بسبب محاولات الرهبان التعدي علي المساحات الصحراوية المجاورة، بغرض ضمها للدير.
وأضاف التقرير أنه سبق صدور قرار من وزير الثقافة، بصفته رئيس المجلس الأعلي للآثار، برقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، يوضح حدود الدير كالآتي: «كيلو متر من الجدار الشمالي للدير، وكيلو متر من الجدار الجنوبي و٤٥٠ متراً من الجدار الشرقي، ومن الناحية الغربية حتي حدود جبانة المسيحيين»، وتقدم المسؤولون بالدير بطلب إلي اللجنة الدائمة لهيئة الآثار للموافقة علي بناء سور حول الدير الأثري.
وكما تكرر في مواقع أخري فإن المسؤولين بالدير لم يلتزموا بالحدود المشار إليها، الأمر الذي دعا المجلس الأعلي للآثار إلي إصدار قرار آخر في ٤ مارس ٢٠٠٧، بإزالة تعدي رهبان الدير علي أرض الآثار من الناحية الغربية. والمؤكد أن تكرار هذا النوع من الحوادث يعكس عجز الدولة وضعفها أمام طموحات الكنيسة وضغوط بعض جماعات أقباط المهجر،
ففي الوقت الذي يشتكون فيه من غياب القانون، ويطالبون بتطبيقه في مواجهة اعتداءات البعض، فإنهم يخالفونه بالاعتداء علي الملكية العامة (أو الملكية السايبة)، فقد تركت الحكومة ـ كما هي العادة ـ تمدد الدير غير القانوني بلا رادع ولا حساب تحكمه هيبة القانون لا بطش أجهزة الأمن، حيث رضخت للضغوط المسيحية حتي تداري ضعفها (وأحيانا خيبتها) في التعامل مع طائفية إسلامية أخري انتشرت في كتب تسيء للمسيحيين، وفتاوي تهين عقيدتهم، ومقالات تزدري دينهم، لتنتقل الطائفية من مرحلة التنظيمات الدينية العنيفة التي استهدفت المسيحيين والعلمانيين ورموز الدولة والسياح في الثمانينيات والتسعينيات إلي المجتمع «الطائفي» الذي يكره بعضه البعض ويمارس طائفية وطائفية مضادة كل يوم.
والواقع أن ما يمكن وصفه بـ «الطائفية الجديدة» ظهر في أعقاب جريمة الكشح عام ١٩٩٩، حين كانت الحكومة المصرية سعيدة بإقامة حفل عالمي ليلة رأس السنة في سفح الأهرام لإظهار وجه «مصر الحضاري»، وكانت الهجمات الطائفية غير الحضارية هي التي تجري علي أرض الواقع في صعيد مصر في تناقض صارخ اعتدنا عليه.
وكانت الكشح البداية الحقيقية والإنذار الأقوي الذي دل علي أن هناك خللاً ما أصاب العلاقة بين المواطنين المسلمين والأقباط، وأن المعالجة الأمنية، التي نجحت في حصار جماعات العنف، ستعجز عن التعامل مع المرحلة الجديدة، وأن العنف الذي مارسته عناصر هذه الجماعات قد انتقل من التنظيمات المتطرفة إلي الشارع المتطرف، ومن أفكار الجهاد العقائدية، التي تهدف إلي الثورة علي الحكم وإقامة نظام إسلامي يضع مخالفيهم في الرأي والدين علي أحسن تقدير في مرتبة ثانية، إلي المجتمع بمسلميه وأقباطه.
وتصاعدت حدة الحوادث الطائفية في أعقاب تحولات حدثت في إدارة الدولة وشكل الأداء السياسي (الذي غاب تقريبا)، حيث تصاعد دور الموظفين من رجال الدين الإسلامي، الذين غرسوا في عقول البسطاء مفاهيم شديدة التخلف والسطحية تحرضهم علي الطائفية وتشجعهم علي كراهية العلم، وحتي ما عرف بالدعاة الجدد فقد أثبتوا أنهم مجموعات تليفزيونية ساهمت في تسطيح وعي الشباب بصورة مفزعة أبعدته عن كل ما له علاقة بالعمل العام والنشاط السياسي.
ودعم من دور رجال الدين و«المفكرين» الإسلاميين الرسميين ثقافة إسلامية ارتبطت بأجواء الفوضي العارمة التي أصابت البلاد، فتحول الأذان الذي كان عنصر جذب وسكينة لمعظم المواطنين المصريين إلي صراخ في الميكروفونات دون أي رقيب، وإذا أوقع الحظ العاثر مواطناً مسيحياً مع سائق تاكسي أو ميكروباص أو حتي في بعض باصات الدولة يضع شرائط الوعظ بالصريخ، فسيضطر إلي أن يستمع ساكتا حتي يصل إلي بيته، وحتي لا يهدد الوحدة الوطنية..
وأصبحت المصالح الحكومية الرسمية (المجال المدني العام) مسرحا لأشكال متعددة من الشعارات الدينية وصور رجال دين مسيحيين، تظل مقبولة في المنازل ودور العبادة (المجال الخاص) وليس في مؤسسات الدولة المدنية.
وقد أسهم هذا المناخ في دفع الآخر القبطي إلي الانسحاب من هذا المجال العام المفعم بالصراخ الديني وبالمظاهر الدينية لا القيم الدينية، وبات من المؤكد أن الثقافة الإسلامية السائدة حاليا لم تمثل عنصراً مساعدا يدفع الجانب الأكبر من المسيحيين إلي التصالح مع الإسلام كما حدث من قبل، بل للأسف دفعتهم إلي إبداء حساسية مفرطة تجاه كل ما هو إسلامي، وعمقتها الجهات التي احتموا بها كالكنيسة وبعض جماعات أقباط المهجر.
ولم تكتف هذه المؤسسات باستقبال «شعبها» بترحاب كبير، إنما هيمنت علي عقله في السياسة والدين والنشاط الاجتماعي، فاختارت أن تكون أقرب إلي كل التيارات المتعصبة في الغرب والولايات المتحدة، وتعمل علي تكوين وعي جيل لا علاقة له بكل قضايا مصر السياسية والاقتصادية، فالعالم بدوره منقسم إلي أهل الخير المسيحيين وأهل الشر المسلمين، وردود الفعل والاحتجاج الصاخب تأتي فقط حين يتعلق الأمر بحادثة ضحاياها من المسيحيين، أما حين يعتقل مئات المصريين أو يعذبون في أقسام الشرطة أو يتظاهرون احتجاجا علي الغلاء والفساد وغيرها فهي كلها أمور خارج اهتماماتهم الطائفية.
فهل يعقل أن تتحول حادثة الاعتداء علي دير أبوفانا بكل ملابساتها إلي حديث حمل عنوان «مازال الغزو العربي لمصر مستمراً» كما ذكرت منظمة أقباط الولايات المتحدة في قراءة مغلوطة للتاريخ تصل في بعض الأحيان إلي العنصرية في كل ما يتعلق بالعرب والمسلمين، وهل توجد أي علاقة بين ما جري في دير أبوفانا بالمنيا والفتح العربي لمصر منذ ١٤ قرنا، وما هي قيمة مناقشة هذا القضية في سياق هذه الحادثة؟،
وإذا كان جوهر المشكلة هو غياب دولة القانون، فهو أمر يكتوي بناره المسلمون والمسيحيون، تماما مثل الفوضي والبطالة اللتين ترفرفان علي «عنصري الأمة»، وطائفية مجتمعية تغلغلت بسبب الواقع السياسي الحالي، ولم نعرفها في الأربعينيات والخمسينيات، رغم أننا كنا نعيش منذ قرون في ظل «الفتح العربي»، ولكن الذي تغير هو النظام السياسي، فهل هناك من يعقل؟، نعم وحان الوقت لكي يرتفع صوتهم.
المصرى اليوم
لم يكن حادث دير أبوفانا في محافظة المنيا هو الأول في مسلسل الحوادث الطائفية، وبالتأكيد لن يكون الأخير، فالحادث الذي أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين، معظمهم من رهبان الدير، كشف عن أزمة عميقة في طريقة تعاطي الدولة مع الملف القبطي، مثلما هو حادث مع باقي الملفات.
وتعود القصة ـ كما أشار زميلنا محمد رضوان علي صفحات «المصري اليوم» في ٨ يونيو الماضي في واحد من أكثر التعليقات اتزانا ومهنية حول الموضوع ـ إلي أن الخلافات علي المنطقة المحيطة بدير «أبوفانا» بملوي، تعود إلي بداية عام ٢٠٠٥، وأنها شهدت في العامين الأخيرين عدداً من المشاجرات والمعارك المسلحة، بين مسؤولي الدير وأهالي المنطقة، بسبب محاولات الرهبان التعدي علي المساحات الصحراوية المجاورة، بغرض ضمها للدير.
وأضاف التقرير أنه سبق صدور قرار من وزير الثقافة، بصفته رئيس المجلس الأعلي للآثار، برقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، يوضح حدود الدير كالآتي: «كيلو متر من الجدار الشمالي للدير، وكيلو متر من الجدار الجنوبي و٤٥٠ متراً من الجدار الشرقي، ومن الناحية الغربية حتي حدود جبانة المسيحيين»، وتقدم المسؤولون بالدير بطلب إلي اللجنة الدائمة لهيئة الآثار للموافقة علي بناء سور حول الدير الأثري.
وكما تكرر في مواقع أخري فإن المسؤولين بالدير لم يلتزموا بالحدود المشار إليها، الأمر الذي دعا المجلس الأعلي للآثار إلي إصدار قرار آخر في ٤ مارس ٢٠٠٧، بإزالة تعدي رهبان الدير علي أرض الآثار من الناحية الغربية. والمؤكد أن تكرار هذا النوع من الحوادث يعكس عجز الدولة وضعفها أمام طموحات الكنيسة وضغوط بعض جماعات أقباط المهجر،
ففي الوقت الذي يشتكون فيه من غياب القانون، ويطالبون بتطبيقه في مواجهة اعتداءات البعض، فإنهم يخالفونه بالاعتداء علي الملكية العامة (أو الملكية السايبة)، فقد تركت الحكومة ـ كما هي العادة ـ تمدد الدير غير القانوني بلا رادع ولا حساب تحكمه هيبة القانون لا بطش أجهزة الأمن، حيث رضخت للضغوط المسيحية حتي تداري ضعفها (وأحيانا خيبتها) في التعامل مع طائفية إسلامية أخري انتشرت في كتب تسيء للمسيحيين، وفتاوي تهين عقيدتهم، ومقالات تزدري دينهم، لتنتقل الطائفية من مرحلة التنظيمات الدينية العنيفة التي استهدفت المسيحيين والعلمانيين ورموز الدولة والسياح في الثمانينيات والتسعينيات إلي المجتمع «الطائفي» الذي يكره بعضه البعض ويمارس طائفية وطائفية مضادة كل يوم.
والواقع أن ما يمكن وصفه بـ «الطائفية الجديدة» ظهر في أعقاب جريمة الكشح عام ١٩٩٩، حين كانت الحكومة المصرية سعيدة بإقامة حفل عالمي ليلة رأس السنة في سفح الأهرام لإظهار وجه «مصر الحضاري»، وكانت الهجمات الطائفية غير الحضارية هي التي تجري علي أرض الواقع في صعيد مصر في تناقض صارخ اعتدنا عليه.
وكانت الكشح البداية الحقيقية والإنذار الأقوي الذي دل علي أن هناك خللاً ما أصاب العلاقة بين المواطنين المسلمين والأقباط، وأن المعالجة الأمنية، التي نجحت في حصار جماعات العنف، ستعجز عن التعامل مع المرحلة الجديدة، وأن العنف الذي مارسته عناصر هذه الجماعات قد انتقل من التنظيمات المتطرفة إلي الشارع المتطرف، ومن أفكار الجهاد العقائدية، التي تهدف إلي الثورة علي الحكم وإقامة نظام إسلامي يضع مخالفيهم في الرأي والدين علي أحسن تقدير في مرتبة ثانية، إلي المجتمع بمسلميه وأقباطه.
وتصاعدت حدة الحوادث الطائفية في أعقاب تحولات حدثت في إدارة الدولة وشكل الأداء السياسي (الذي غاب تقريبا)، حيث تصاعد دور الموظفين من رجال الدين الإسلامي، الذين غرسوا في عقول البسطاء مفاهيم شديدة التخلف والسطحية تحرضهم علي الطائفية وتشجعهم علي كراهية العلم، وحتي ما عرف بالدعاة الجدد فقد أثبتوا أنهم مجموعات تليفزيونية ساهمت في تسطيح وعي الشباب بصورة مفزعة أبعدته عن كل ما له علاقة بالعمل العام والنشاط السياسي.
ودعم من دور رجال الدين و«المفكرين» الإسلاميين الرسميين ثقافة إسلامية ارتبطت بأجواء الفوضي العارمة التي أصابت البلاد، فتحول الأذان الذي كان عنصر جذب وسكينة لمعظم المواطنين المصريين إلي صراخ في الميكروفونات دون أي رقيب، وإذا أوقع الحظ العاثر مواطناً مسيحياً مع سائق تاكسي أو ميكروباص أو حتي في بعض باصات الدولة يضع شرائط الوعظ بالصريخ، فسيضطر إلي أن يستمع ساكتا حتي يصل إلي بيته، وحتي لا يهدد الوحدة الوطنية..
وأصبحت المصالح الحكومية الرسمية (المجال المدني العام) مسرحا لأشكال متعددة من الشعارات الدينية وصور رجال دين مسيحيين، تظل مقبولة في المنازل ودور العبادة (المجال الخاص) وليس في مؤسسات الدولة المدنية.
وقد أسهم هذا المناخ في دفع الآخر القبطي إلي الانسحاب من هذا المجال العام المفعم بالصراخ الديني وبالمظاهر الدينية لا القيم الدينية، وبات من المؤكد أن الثقافة الإسلامية السائدة حاليا لم تمثل عنصراً مساعدا يدفع الجانب الأكبر من المسيحيين إلي التصالح مع الإسلام كما حدث من قبل، بل للأسف دفعتهم إلي إبداء حساسية مفرطة تجاه كل ما هو إسلامي، وعمقتها الجهات التي احتموا بها كالكنيسة وبعض جماعات أقباط المهجر.
ولم تكتف هذه المؤسسات باستقبال «شعبها» بترحاب كبير، إنما هيمنت علي عقله في السياسة والدين والنشاط الاجتماعي، فاختارت أن تكون أقرب إلي كل التيارات المتعصبة في الغرب والولايات المتحدة، وتعمل علي تكوين وعي جيل لا علاقة له بكل قضايا مصر السياسية والاقتصادية، فالعالم بدوره منقسم إلي أهل الخير المسيحيين وأهل الشر المسلمين، وردود الفعل والاحتجاج الصاخب تأتي فقط حين يتعلق الأمر بحادثة ضحاياها من المسيحيين، أما حين يعتقل مئات المصريين أو يعذبون في أقسام الشرطة أو يتظاهرون احتجاجا علي الغلاء والفساد وغيرها فهي كلها أمور خارج اهتماماتهم الطائفية.
فهل يعقل أن تتحول حادثة الاعتداء علي دير أبوفانا بكل ملابساتها إلي حديث حمل عنوان «مازال الغزو العربي لمصر مستمراً» كما ذكرت منظمة أقباط الولايات المتحدة في قراءة مغلوطة للتاريخ تصل في بعض الأحيان إلي العنصرية في كل ما يتعلق بالعرب والمسلمين، وهل توجد أي علاقة بين ما جري في دير أبوفانا بالمنيا والفتح العربي لمصر منذ ١٤ قرنا، وما هي قيمة مناقشة هذا القضية في سياق هذه الحادثة؟،
وإذا كان جوهر المشكلة هو غياب دولة القانون، فهو أمر يكتوي بناره المسلمون والمسيحيون، تماما مثل الفوضي والبطالة اللتين ترفرفان علي «عنصري الأمة»، وطائفية مجتمعية تغلغلت بسبب الواقع السياسي الحالي، ولم نعرفها في الأربعينيات والخمسينيات، رغم أننا كنا نعيش منذ قرون في ظل «الفتح العربي»، ولكن الذي تغير هو النظام السياسي، فهل هناك من يعقل؟، نعم وحان الوقت لكي يرتفع صوتهم.
المصرى اليوم


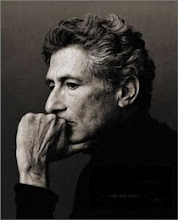



























ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق